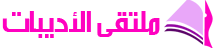أعتبر النص السردي الجيد هو الذي يخاطب أعماقنا، أرواحنا، يتيح لنا قراءة ذواتنا، يكشف عن دواخلنا، وأحيانا قد يكشف عن أشياء لا نعرفها عنا إلا بعد قراءتنا له، يستدرجنا للاستواء على ناره الملتهبة، فنستسلم لتورطنا في دائرة سلطته، ومرآة صوره.. بذلك يكون “السرد في وجودنا أوسع من مجرد رصد لإيقاع زمني يعود إلى وقائع مصدرها حقائق الوجود وحدها، ويكون أشمل أيضا مما يمكن أن يُصنّف ضمن تفصيل سيري يحتمي بوقائع تَبْنيها حياة فرد معزول لا امتداد لها خارج ملكوته الخاص”[1]. الأمر الذي يجعلنا ندرك أنه بفضل السرد “نبني ونعيد بناء الحاضر والمستقبل وقد نقوم بخلقهما. وفي هذا الخلق تختلط الذاكرة مع المتخيل، وحتى ونحن نبتدع عوالم تخييلية ممكنة، فإننا لا نبرح مكاننا في العالم المألوف لدينا: إننا ندرجه ضمن ذواتنا لكي نخلق آخر يمكن أن يوجد” حسب تعبير جيروم برينير.
وروايات عبد الجليل الوزاني كلها استدرجتني للهيبها، فقرأت ذاتي فيها، وارتهنتْ قراءتي لها باقتراح أفق يسعى إلى استمطار الذوق بوصفه قيمة جوهرية، يخدم الفعل الإبداعي، ويكشف عن جماليته، ونكهته الخاصة، بتوجيه من المرجعيات والمعاير النقدية الملائمة. ولعل مقولة بورخيس “إن أعظم ما يمتلكه الإنسان هو الخيال” تنطبق على روايات عبد الجليل، الذي استثمر قوة خياله لإبداع عوالم، جعلته مفتونا بصنع ذاكرة للمكان عبر توليد التخييل السردي من مفردات ما يحيط به من معطيات واقعية، وجعلتني أضيف إلى مقولة بورخيس: “من أجمل ما يمتلكه الإنسان نعمة التذوق”.
والمتأمل لهذه العوالم الروائية، يدرك أن عبد الجليل قد حقق تراكما نوعيا داخل الرواية المغربية، والعربية، لما اشتملت عليه:
ـ من تنوع الموضوعات الموزعة على أسئلة الذات والهوية والإبداع، والحريصة على البحث عن إنسانية الإنسان، من خلال النبش في حفريات التحولات الاجتماعية والحضارية بصفة عامة التي تحاصر تطلع الإنسان نحو تحقيق إنسانيته، والكشف عن هشاشة الواقع الموبوء، الذي يعيق النضج الحقيقي للوعي.
ـ ومن اختيار أسلوبي، على تنوع صيغه التعبيرية والتصويرية، يصب في إطار العرض الواقعي، وينمّ عن خبرة تستجيب لخصائص الجنس الروائي وتكويناته الجمالية، تسعى نحو خدمة رؤاه ومواقفه وقدرته على خلق الاستجابة عند المتلقي.
ورواية امرأة في الظل التي اجتمعنا اليوم لمقاربتها خير أنموذج لذلك. فهي تعلو بصوت ضمن أصوات متعددة، يلامس الضمير الجمعي، عبر استنطاق أزمة الذات المواجهة لأشكال الخيبات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والقيام بالشهادة على واقع ينوء بمختلف آليات طحن النفوس والأرواح. واستصحاب الشهادة على الواقع، يتجلى في كل رواياته، وأعلن عنه بوضوح في مستهل رواية احتراق في زمن الصقيع حين قال: “ لست مؤرخا، و لا أسعى لنيل شرف المؤرخين و حظوتهم ، لكنني شاهد عيان ، يأبى قلمه إلا أن يلامس واقعه”.
ويعتبر عبد الجليل أن أحداث روايته “امرأة في الظل” امتداد لرواية “احتراق في زمن الصقيع” التي أضاع في نهايتها امرأة وأراد إعادتها إلى الساحة الروائية، من خلال هذه الرواية، في شخص “زينب”. فلحظة القراءة في الرواية تنبثق قبل بداية تشكل عالمها السردي، حين يستهل الكاتب الرواية استهلالا ذكيا، ويقوم بتوجيه المتلقي نحو ما أسماه بأسباب التنزيل، كأنه عزّ عليه أن تُتّهم شخصية جمال، وهي الشخصية المركزية في رواية “احتراق في زمن الصقيع” بالاغتصاب أو غيرها من الأوصاف السلبية، فيقرر عبر رواية امرأة في الظل ردّ الاعتبار له، يقول بعد ذكر ما نعته بشغب واستفزاز أصدقائه النقاد: “لا أبالغ إذا قلت إنني أُرقت تفكيرا في هذه الشخصية، وحزّ في نفسي أن تنفلت للناس بالصورة التي تلقفوها بها. استمر هذا معي طويلا إلى أن وقفت عليّ ذات فجر زينب بنت الرايس امحمد الصافي التي تعتبر الضحية الوحيدة لجمال حسب تأويل هؤلاء النقاد..”[2]. فهو استهلال يحاول امتلاك سلطة توجيه المتلقي نحو أفق يقدم فيه الكاتب مجموعة من المسوغات التي دفعته إلى إحياء شخصية من شخصيات روايته الأخرى، ويقطع عليه طريق التوقع والتأويل خارج ما يقدمه.
كما أن العنوان لم يأت بطريقة اعتباطية، بل هو خطاب مفكر فيه، بوصفه أول ما يواجه المتلقي، وهو القاعدة التي ترن دائما وتخلخل الأفكار لديه، حسب تعبير إمبرتو إيكو[3]، يشير إلى مجموعة من المقاصد أراد الكاتب أن يسلط عليها الأضواء، انطلاقا من كونه عتبة إشارية دالة، وإن كان تأويلها يخضع إلى مرجعيات المتلقي وآلياته في صناعة المعنى، إلا أنها تثير لديه شهوة المعرفة، من خلال الكشف في المتن عما لا نعرفه عن زينب. فهي حاضرة بوصفها علامة مركزية، يُبنى عليها نسيج النص، جاء بها الكاتب نكرة، وإن عرفها داخل المتن في المشهد الثاني، لكنه قصد بها البحث عن ذات كل امرأة تعيش في مجتمع الظل والهامش، تعاني من الظروف القاسية.
وإذا كانت رواية احتراق في زمن الصقيع رغم امتثالها لشرط التخييل، تستند في صياغة سردها إلى شكل السيرة الذاتية، حيث يسترجع السارد ذكرياته في مرحلة الطلب الجامعي إبان فترة حرجة من تاريخ المغرب، خاصة المنطقة الشمالية، التي عرفت احتجاجات بسبب التضييق على الحريات السياسية والنقابية والطلابية، جوبهت بعنف أمني خطير، فإنها في رواية امرأة في الظل تستند في صياغة سردها إلى شكل أدبي مغاير هو الرسالة، حيث يهيمن ضمير المتكلم الموجه إلى المخاطب. وهو تخييل يجعل الساردة في الرواية تسترجع حكايتها، وتعيد اكتشاف سيرتها لتقديمها إلى المخاطب، بوصفها وثيقة حقيقية، تحولها إلى موضوع للتأمل. حيث شخصية زينب الساردة تستقطب باقي الشخصيات، وتجعلها تدور في فلكها. فالساردة فاعل مركزي في صنع الأحداث، تتولى ربط وضبط مجريات الحكاية ودلالات وقائعها، وتَعقُّب شخصياتها قصد الإلمام بعلاقتها معهم، وما تفرزه هذه العلاقة من مواقف إنسانية، وما تفرضه من انصهار كلي أو جزئي بالمكان والزمان.
ظلال الذات والهوية:
والرواية مكونة من أربعين مشهدا تحكي بتفصيل عن امرأة، تحاول التأريخ للحظات حاسمة في حياتها، ناتجة عن عشق اجتاحها عقب تحولات، تداخل فيها محكي الذات، مع محكي الواقع المتدفق، الذي يحيط بمواقف وتفاصيل عاصفة أمام صخب الواقع. ورغم المعاناة وقساوة ما عاشته، إلا أن الساردة/ العاشقة تنتصر لعشقها، فهي لم تندم أبدا عليه، رغم الخطوط الحمراء الصارمة التي وضعتها لنفسها، وتستحضر حبيبها بصورة مشرقة دون لوم أم عتاب: “والمؤكد أن انزوائي بشقتي بعيدة عن القرف، مكنني من استحضارك كلما اشتقت إليك، كنتَ تأتيني كيفما أريد وبالشكل الذي أحب، أقول لك كل ما بخاطري، وما أكنه لك من حب، كنتَ سخيا معطاء، لا ترفض لي طلبا ولا تعترض، كنت رجلا طائعا حنونا، أجدك مصغيا لحديثي، رقيقا في همسك..”[4]. فهذه الصورة تفرزها مخيلة الساردة عن الرجل الذي أحبته، كي تستطيع مواجهة الحقيقة التي تعيشها.
والساردة تسعى منذ المشهد الأول نحو تحقيق ذاتها، وإخراجها من انعكاسات ظلها الذي جعلها تنزوي وتهرب، من خلال القبض على فعل الاستمرارية الذي لا يمكن أن يتجلى إلا عبر فعل الكتابة نفسها، والاحتفاء بالحكي، المستشرف لمشاهد وصور سردية محكمة الصنع والإبداع، تقول: “أجلس بالمكان نفسه، فوق الصخرة عينها.. والأمواج المترادفة المتدافعة هي هي، لم تتعب ولم تكل..زمع أننا لا نسبح في النهر مرتين، فمن يدري قد تكون المياه نفسها حاضرة بالرغم من مرور عقدين ونيف من الزمن على ما حدث. وأجدني أهمس لك بكلمات..بل أكتب لك بأحرف مرتعشة، أوراقا لا أعلم هل ستقرأها يوما، لذلك سأكتب، وأكتب..”[5]. كما أنها في الفقرة الأولى من المشهد السادس تقدم تلخيصا مكثفا بليغا عن الرواية، تغري به المتلقي على المتابعة وتفكيك مفردات ذاتها وهويتها[6]. وكل مشهد من هذه المشاهد يقدم شخصيات أو أحداثا تتشكل في سياق امتداد الحكاية، تتشعب تكويناتها السردية، تستبطن مواقف وقيما، تجسّدت جذورها في الواقع، وامتدت متسللة في انسياب بلاغي جميل نحو المتلقي.
وتنطلق أحداث الرواية من نفس المكان الذي انتهت فيه شخصية زينب في رواية “احتراق في زمن الصقيع”، تسترجع فيه الساردة مسير حياتها، منذ أن رجع جمال إلى أهله ومتابعة حياته العادية، بعد أن تركها تعاني مرارة الفراق وحرقته إلى أن عادت إليه حين أدركت أنه لا أمل من شفائها من المرض الذي أصابها، وأن أجلها قد اقترب، لتنهي حكايتها بتحميل المخاطب المسؤولية. فرغم أن السرد موجه نحو جمال توصيه بتحمل مسؤولية ولده، إلا أن الخطاب موجه ضمنيا للمتلقي، فهي رسالة البحث عن الذات، وتوثيقها من خلال الكتابة، نستشفها من خلال خاتمة الرواية، كما نستصحبها من خلال فضح ألوان من الفساد الكائن في زوايا المكان الذي يحتوي أصنافا من البشر المهمشين. لنتأمل هذا الفضاء: “في الأيام الأولى لمقامي ببيت خالتي أم كلثوم، اكتشفت أنني أقيم بحي الكادحين المعذبين في الأرض، كان بيتها أحد البيوت المشكلة لسلسلة من البيوت المشيدة بشكل عشوائي في وقت العتمة أو التعامي من طرف رجال السلطة الساهرين على مصالحهم الشخصية.حجرات صغيرة ضيقة وضعت كيفما اتفق، تجاورها دور الصفيح والقصدير، أزقة ملتوية بعضها يفضي إلى زقاق آخر، وبعضها ينتهي بممر مغلق، متاهات مبعثرة تعلو وتهبط بعلو الأرض وهبوطها بقدم جبل درسة، وكانت مجاري الصرف الصحي تصب في الأزقة مشكلة بركا آسنة هنا وهناك، تفوح منها شتى أنواع الروائح النتنة، تنحدر بعضها لتصل مجرى خندق الزربوح اليابسة والتي لا تجري بها المياه إلا عند سقوط الأمطار.. وفوق هذا وذاك الاكتظاظ البشري الشديد الذي توشي عنه كثرة الأطفال اللاهين بالأزقة طوال اليوم”[7]. إنه فضاء يقوم بوظيفة تراجيدية تتغلغل في وجدان المتلقي، ويشكل محفزا على توليد سرد يتنامى ليضيئ عتمات حياة شخصيات تعيش فيه، بما يكتنفها من ظروف قاسية، وانكسارات نفسية طاغية.
وبين البداية والنهاية تفاصيل حياة قلقة متوترة، حيث نجد الساردة توجه رسالة مطولة إلى جمال الأحمدي، الغائب الحاضر في بناء الرواية، الذي تستدرجنا زينب من خلاله من أجل إغوائنا بتتبع الحكاية التي سترويها عن علاقتهما. تلك العلاقة التي ستسفر عن حملها، وبالتالي محو الهوية عنها بسبب موتها المتوهم/ هروبها، حيث يقوم الحكي بمهمة استرجاعها من أجل تثبيت هوية ولدها. ولعل المشهد الأخير الذي جاء مكثفا ومختزلا مجموعة من الأحداث المتروكة للقارئ تخيلها، والذي تحكي فيه الساردة رجوعها إلى ترغة، ولقائها بأخيها السعيد وأسرته، وانزوائها في الغرفة التي شهدت حبها لجمال يقوم بوظيفة استرجاع الهوية وإثباتها.
والحقيقة، فإن التجربة
الروائية عند عبد الجليل الوزاني التهامي تعدّ من أخصب التجارب الروائية العربية
التي انطلقت من المحلي لتجلية دلالات مختلفة وقضايا متعددة، واستطاعت تحقيق صيرورة
تشكل جوهر الإنسان وحياته، بآليات متنوعة لإنتاج المعنى.
[1] ـ السرد وسلطان الزمن، موقع سعيد بنكراد.
[2] ـ امرأة في الظل أو ما لم نعرف عن زينب، عبد الجليل الوزاني التهامي، الحائزة على جائزة كتارا للرواية العربية.ط1. 2016.ص7.
[3] ـ النص الموازي للرواية، شعيب حليفي، ص90.
[4] ـ امرأة في الظل، ص 127.
[5] ـ امرأة في الظل، ص11.
[6] ـ انظر ص 31 من الرواية.
[7]ـ الرواية، ص37.