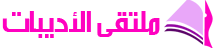من الأشكال السردية العربية القديمة ما يُعرف بأدب الرحلة اليوم، لكنه غالبا ما عُدّ ضمن الوثائق التاريخية والجغرافية الدالة على المظاهر الثقافية للفترة التي عاش فيها صاحب الرحلة، . ورغم ذلك فقد استطاعت على مر العصور أن تحقق لنفسها خصائص ومكونات جمالية وفنية ألحقتها ضمن الفنون الأدبية . ومحاولة استكناه ملامح الأدبية فيها تكشف جملة من الصيغ الجمالية التي تدخلها في مجال الأدب. فهي رغم استنادها إلى الحقيقة و المرجعية الصادقة ومناشدة الفائدة العلمية المباشرة، وابتعادها عن التخييل الذي هو صفة لازمة لأي نص جمالي، إلا أنها عوضته بالكثافة البلاغية، كما أنها تجسد تجربة إبداعية وإنسانية تدفع الباحث لمحاولة الكشف عن تشكيلاتها الجمالية المختلفة التي صيغت فيها.
من هنا، يهدف هذا البحث الكشف عن بعض العناصر الجمالية المكونة لآخر الرحلات الأندلسية المتجهة نحو الحجاز، وهي رحلة أبي الحسن على القلصادي الأندلسي[1].
يُعدّ أبو الحسن بن محمد بن محمد بن علي القرشي البسطي[2] الشهير بالقلصادي من علماء الأندلس الذين عايشوا احتضار معقل من معاقل الإسلام وجنة من جنانه في القرن التاسع الهجري، حيث كان الفضاء السياسي قاتما، الأمر الذي أرخى ظلالا مضطربة على المستوى العلمي. وقد حدث القلصادي بذلك في ترجمته لشيخه أبي الحسن علي اللخمي القرباقي[3]، وذكر أن سوق العلم لم تعد رائجة ببسطة مسقط رأسه، ولا بالحصون التابعة لها مثل شوجر وقنالش، بعد أن كانت الحركة العلمية مزدهرة، والتنافس قائما بين العلماء، وعبر عن حزنه وأساه لتردي الحالة السياسية والعلمية التي أصبحت عليها مملكة غرناطة بإنشاده البيت الجاري مجرى الأمثال:
لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى استامها كل مفلس
ومع هذا فإن القلصادي لم يتخل عن طلب العلم والحرص على الاستفادة من علماء الأندلس، فيذكر في رحلته أنه تلقى دراسته الأولى على أيدي شيوخ بسطة وغيرها من المدن والقرى المجاورة لبلدته، من أمثال أبي الحسن علي بن عزيز وأبي أحمد بن أبي يحيى وأبي الحسن علي اللخمي وغيرهم[4]، كما كان يتردد على غرناطة للاستفادة من علمائها. وحرصه العلمي لم يقف به عند حدود الأندلس وإنما جعله يلتمس العلم في تونس والمشرق، رغم المخاطر التي كانت تكتنف بلاده، والأخطار التي كانت تترصد في الطريق. ولم يكن يتلقى العلم فقط، بل يقدم معارفه وعلمه ويُدرّس في كل البقاع التي كان يزورها حتى قيل عنه في مجال التدريس: “كان على قدم في الاجتهاد والتدريس”، ولذلك نجده يذكر في حديثه عن نشاطه العلمي أنه يطلب العلم قراءة وإقراء. وفي ذلك يقول أحد تلاميذه وهو أبو عبد الله محمد الملالي : ” كان عالما فاضلا شريف الأخلاق سالم الصدر، له تآليف أكثرها في الحساب والفرائض كشرحه العجيب على تلخيص ابن البنا وشرحه العجيب على الحوفي، انتفع عليه خلق كثير”، ويصفه المقري بأنه كان كثير المواظبة على الدرس والكتابة والتأليف.
وفي سنة 840 ه بدأ القلصادي رحلته العلمية الحجازية، وكان أول مرفئ علمي له مدينة تلمسان التي كانت تعيش أزهى أيام حياتها الثقافية[5]، فأخذ عن أشهر علمائها في ذلك العهد من أمثال محمد بن مرزوق المعروف بالحفيد وأبي مهدي عيسي الرتيمي وأبي عبد الله محمد الشريف التلمساني وغيرهم. كما عقد حلقات الدرس والإقراء. وظل في تلمسان حوالي ثمان سنوات، فضلا عن سبعة أشهر قضاها فيها في طريق عودته إلى الأندلس. وكانت تونس المحطة العلمية الثانية التي حط بها رَحله، وعبر في رحلته عن إعجابه بفضائها الثقافي لما رأى فيها من :”سوق العلم حينئذ نافقة وينابيع العلوم على اختلافها مغدقة”[6]، وتلقى عن علمائها وشيوخها أمثال أبي العباس أحمد القلشاني وأبي عبد الله محمد الدهان وأبي عبد الله محمد بن عقاب الجذامي وغيرهم. وكانت إقامته بها سنة كاملة. ثم اتجه القلصادي إلى القاهرة عبر جربة وطرابلس الغرب والإسكندرية. وفيها أخذ عن الشيخين زين الدين طاهر النويري المالكي وعلم الدين الحصني الشافعي. ولم تتجاوز إقامته بالقاهرة سوى ستة أشهر، إلا أنه في عودته من الديار المقدسة ظل بها أكثر من ثلاثة عشر شهرا اشتغل فيها بطلب العلم والتدريس والإقراء. ثم انطلق نحو الديار المقدسة لتأدية العمرة ثم مناسك الحج، والاشتغال بتأليف كتاب “شرح فرائض ابن الحاجب” كما اشتغل برواية الأحاديث النبوية عن الشيخ المحدث أبي الفتح الحسني المراغي الذي أجاز القلصادي في أسانيده على كتب الأحاديث. وقد استمرت رحلة القلصادي حوالي خمسة عشر سنة، ذهابا وإيابا، حرص فيها على طلب العلم وتدريسه، ولقاء شيوخ وعلماء عصره في المغرب العربي ومشرقه، ثم رجع إلى مسقط رأسه قبل أن ينتقل إلى غرناطة ويستقر بها حينا من الزمن، لكن مع كثرة الاضطرابات والخطر المتفاقم فيها خرج منها حوالي سنة 888ه[7]ونزل بتلمسان ثم رحل إلى باجة إفريقية ومكث بها ثلاثة سنوات وأربعة أشهر إلى أن انتقل إلى جوار ربه بها سنة 891ه.
وكان في كل بلدة ينزل بها يؤلف عددا من التصانيف العلميية، من ذلك ما ألفه في تونس من مثل” انكشاف الجلباب عن قانون الحساب” وغير ذلك من المصنفات التي عُدَّ بها ” آخر من له التآليف الكثيرة من أئمة الاندلس”. ومن الأئمة الذين تتلمذوا على يديه الشيخ أحمد بن علي بن داود البلوي، الذي يصف شيخه القلصادي بقوله: ” شيخنا الامام العالم الصالح، خاتمة الحساب والفرضيين أبو الحسن، أصله من بسطة وبها تفقه على شيخ طبقتها وبقية شيوخها أبي الحسن القرباقي، ثم انتقل لغرناطة فاستوطنها لأخذ العلم فأخذ بها عن جملة شيوخها كالأستاذ أبي إسحاق بن فتوح والامام المشاور أبي عبد الله السرقسطي وغيرهما، رحل للشرق فلقي كثيرا وانتفع به(…) ثم حج ولقي أعلاما وعاد إلى غرناطة فوطنها حتى حل بوطنه ما حل فتحيّل في تخليصه من المشرك، فأدركته المنية بباجة من إفريقيا منتصف ذي الحجة سنة إحدى وتسعين وثمانمائة”. ونص البلوي يبين أن القلصادي لم يكن مهتما بالعلم فقط، وإنما كان مشاركا في الخروج ببلاده من البلاء الاستعماري الذين اجتاحها. لكن المصادر التي تؤكد هذه المشاركة لم تُفص{ل في كيفيتها وطبيعتها إلا بألفاظ غامضة من مثل ” فتحيل في تخليصه من المشرك” نستشف منها اهتمامه وفاعليته ولا ندرك كيفية عمله في تخليص بلاده من المستعمر[8].
والرحلة التي بين أيدينا، بالإضافة إلى قيمتها الأدبية، تعتبر وثيقة من أهم الوثائق التي أرخت للدرس العلمي في الاندلس، خاصة في فترة من أحلك الفترات التي مرت بها هذه الربوع الإسلامية، وهي سقوطها الأخير في يد الصليبيين وخروج المسلمين منها. ويرتبط عنوانها “تمهيد الطالب، ومنتهى الراغب، إلى أعلى المنازل والمناقب” ارتباطا وثيقا ببنية النص الرحلي، ذلك أنه يشير إلى الغاية من كتابته، وهي كما صرح في المقدمة بقوله[9]: “فالمقصود من هذا الموضوع أن يكون معرِّفا بأشياخي من أهل العلم الذين أخذت عنهم رضي الله وأرضاهم، وبرحلتي من بسطة مسقط رأسي وموضع أول أنفاسي، مقر الألفة والأنس من جزيرة الاندلس، أدامها الله للإسلام وحماها من عبدة الاصنام”. واستخدام الكاتب للجملتين الإسميتين وشبه الجملة في العنوان يدل على الثبات في الطلب والرغبة، وعلى قصدية التوجه بالرحلة، التي هي الارتقاء بالذات في السلم المعرفي إلى مرتبة الرفعة لنيل الشرف العلمي.
وهذا التوجه ليس مقصورا على الذات، رغم اعتبارها موضوعا أساسا في الرحلة، وإنما موجه أيضا إلى طالب العلم الراغب في التلقي والارتقاء. وبهذا تكون الرحلة عبارة عن بسط للتجربة التعليمية مما جعلها بؤرة القول، وتعريفا ذاتيا بهاجس التنقل الذي يأخذ بتلابيب المسلم، سواء في طلب العلم أو في تأدية الواجب الديني. وقد نصّ القلصادي على ذلك في أول الرحلة في قوله[10]: “الحمد لله الذي جعل طلب العلم واجبا على البعض من المسلمين، فقال تعالى وهو أصدق القائلين ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين[11])، وفرض الحج على المستطيع من المومنين، وألزمهم التكاليف حجة عليهم ودليلا، فقال سبحانه وتعالى: (ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا[12])”.
وقد استخدم كاتب الرحلة ضمير الأنا المتكلم، ليجعل من نفسه ساردا للرحلة وشخصية فاعلة فيها. فهو الذي قام بالرحلة، لكنه لم يدونها بنفسه، رغم أنها دُوِّنت في حياته. وبذلك جاء في آخرها[13]: “انتهى التقييد المبارك بمحمد الله تعالى وعونه على يدي مقيده لنفسه عبيد الله علي بن القاسم بن علي بن محمد بن أحمد البياضي الانصاري غفر الله ذنوبه وستر في الدارين عيوبه بتاريخ يوم السبت الخامس عشر من شهر ربيع الأول الشريف من عام سبعة وسبعين وثمانمائة ه بموافقة الثاني والعشرين من غشت الاعجمي 1472م، وكان مبدأ نسخه في الشهر الفارط صفر بمدرسة غرناطة أيدها الله”.
إننا أمام نص رحلي مكتوب من طرف شخصين: شخص فاعل في الرحلة هو القلصادي، سردها لشخص ثان “عبيد الله علي بن القاسم البياضي الأنصاري، هو الكاتب الضمني لها، والذي ينقل كلام السارد الحقيقي بين الفعل والسرد. وضمير المتكلم فيها يحيل على المعرفة والإخبار بالحدث التعليمي.
والسفر مهيمن فيها، ولذلك فإن الكتابة عنه تقتضي استخدام لغة تواصلية تستند إلى أنظمة تعبيرية متنوعة، منها ما هو نمطي يتبع طريقة في السرد على غرار الرحلات الاندلسية السابقة، من حيث الابتداء بالبسملة والحمدلة، ونسبة القول إلى الذات الساردة، وإبراز الدافع المباشر من الرحلة، ونوعها واتجاهها ثم اختتامها. ومنها ما هو إبداعي يفسح المجال للصيغ الجمالية أن تتمظهر في تنويعات متميزة ضمن سياق الرحلة. ورحلة القلصادي من الرحلات النمطية التي تتبع سنة الرحلات الاندلسية والمغربية السابقة. ولذلك نجد أن الرغبة في السفر والرحلة نحو الديار المقدسة يبعثه الحنين إلى مهبط الوحي والتشوق لزيارة رسول الله، وحين يقترن هذا الحنين بعمق التشبع بالقيم الإسلامية التي تغذي الميل نحو النظر في الكون والآفاق والتفكر فيها واستجلاء مكامنها، والحث على السعي وراء العلم، كما في رحلة القلصادي ندرك تلك المشاعر التي كانت تصاحب الرحالة المغربي أو الأندلسي وهو يرتاد دور العلم في أنحاء العالم العربي، ويتصل بالعماء والشيوخوأو الأندلس للأخذ عنهم واستجازتهم، كما نتبين الرغبة الكامنة لديه في تدوين تجربته العلمية.
والسفر يفرض التنقل من مكان إلى آخر، ويجعل من الفراق حتمية واقعة تثير في الذات الساردة نوعا من القلق والتوتر. يقول القلصادي واصفا فراقه لشيخه علي اللخمي في بداية سفره بأسلوب حزين[14]: “ثم جئت الشيخ للتوديع، ولهيب الفراق على القلب يذيع، فأذنت النفس للدموع بالانسكاب، وأضرم في القلب نار الشوق والالتهاب، فودعته والجوانح ملتهبة، والدموع منسكبة، والشوق بالقلب لاعب، وغراب البين بالأحبة ناعب، فأكببت على يديه مودعا، وفؤادي من الفراق متوجعا، وعبراتي يتحدرن من المآقي، وزفراتي يتصعدن من التراقي، وكانت خاتمة التلاقي”.
وبما أن الهدف من هذه الرحلة كان هو لقاء العلماء والتعريف بهم كما ذكر في مقدمتها، فقد اتبع الكاتب منهج الرحلات الفهرسية التي توثق ما قرأه عن شيوخه، أو أقرأه لطلبته، وذلك باستعماله لألفاظ معينة من مثل: قرأت عليه كذا.. فقرأت عليه بلفظي.. وقابلت معه.. وحضرت عليه بقراءة غيري وهكذا…
وكان في تعريفه بالشيوخ الذين التقى بهم يروم الإيجاز ولا يتوسع في بسط الأخبار عنهم، ولا يذكر إلا ما يتصفون به من زهد وورع وتفقه. وهي الخصال التي تعجب القلصادي ويركز عليها، ليبين مكانة الشيخ العلمية والدينية. فالشخصيات التي ترجم لها أو التي كان لها دور في رحلته تفتقد الملامح الفسيولوجية، إلا أن تأثيره ببعضها جعله يفصل القول في بعض تصرفاتها المتسمة بالصلاح والتقوى، من مثل قوله في شيخه محمد بن مرزوق بعد تحليته بمجموعة من الصفات[15]: “كان رضى الله عنه من رجال الدنيا الآخرة، وكانت أوقاته كلها معمورة بالطاعات ليلا ونهارا: من صلاة وقراءة قرآن وتدريس علم وفتيا وتصنيف، وكانت له أوراد معاومة، وأوقات مشهودة، وكان له بالعلم عناية تكشف بها العماية، ودراية تعضدها الرواية، ونباهة تكسب النزاهة” ومثل هذا التعريف غير كاف لتحديد سمات شخصيات الرحلة، ولكنه يبرز تلك العلاقة القائمة بينها وبين الرحالة، والتي كانت ثمرة الاحتكاك واللقاء العلمي، كما تلقي الضوء على شخصية الكاتب نفسه من حيث مستواه العلمي والأخلاقي.
وحرصا على إثبات الدافع للكتابة، فقد مزج القلصادي بين منهج الرحلات الفهرسية التوثيقي وبين وصفه للبلدان التي مر منها أثناء الذهاب والإياب، منذ خروجه من بسطة إلى أن وصل إلى البلد الحرام. وتحدث عن طريق العودة بعد زيارة المدينة المنورة إثر أداء مناسك الحج إلى أن وصل ميناء ألميرية الاندلسي، وقصد مسقط رأسه بسطة. وقد دفعه حرصه التوثيقي إلى التأريخ الدقيق لانتقاله من مكان إلى آخر.
وهكذا نرى أن السفر يشكل بنية كاملة تحكم نص الرحلة برمته، وينفتح على وصف فضاءات متعددة ومختارة، كما ينفتح على خطابات متنوعة سعت من خلالها إلى معانقة أبعاد جمالية لتجسيد تجربة تدخل في مجال الأدب.
ويعد المكان مكونا مركزيا في الرحلة، لذلك نجد القلصادي يركز عليه في رحلته، فيذكر المكان الذي انطلقت منه، وهو فضاء حميمي بالنسبة للسارد، فنجده يقول عنه بأسلوب مفعم بالمرارة التي يحسها من شدة الخوف عليه[16] : “ثم ارتحلت عن مسقط رأسي، ومحل أنسي، مع أبناء جنسي، بسكة سقى الله أرجاءها المشرقة وأغصانها المورقة شآبيب الاحسان، ومهدها بالهدنة والأمان”. والوعي بالحالة التي كانت تهدد أمن البلاد في تلك الفترة من حياة الاندلس جلي وواضح في دعاء الكاتب كلما أتى ذكرها في الرحلة،. ثم يقول في وصفها بجمل قصيرة مسجوعة من غير تكليف حيث ينفذ إلى الغرض مباشرة:[17]“دار تخجل منها الدور، وتقصر عنها القصور، وتقر لها بالقصور، مع ما حوته من المحاسن والفضائل، من صحة ّأجسام أهلها وما طبعوا عليه من كرم الشمائل لهوائها الصحيح، وفضائها الفسيح، وبحسبك فيها عدم الحرج، لأن داخلها باب الفرج ” ولا يكتفي بهذا الوصف وإنما يستدعي نصوصا نثرية وشعرية تدعم وصفه، مما جعل الرحلة تتفاعل مع خطابات متعددة، تتخلل نسيجها، من مثل استدعائه لنص ابن الخطيب النثري، ونص الأزرق الشعري في وصف بسطة[18]. ومثل هذه الاستدعاءات لا تؤدي دورا تزيينيا، وإنما تقوم بوظيفة الكشف عما يناسب رؤية الكاتب، وتتيح له تحديد موقفه من مجموعة من المسائل، كما تفسح له المجال للوقوف في محطات خارج المكان والزمان قبل أن يتابع السرد، كما في قوله مثلا يذكر شوقه للسفر والارتحال من مكانه[19] :” ثم تحرك خاطري إلى الانتقال، وتشوقت النفس إلى الارتحال، وتذكرت كلام القاضي عبد الوهاب بلسان الحال:
سافر تجد عوضا عمن تفارقه واتعب فان لذيذ العيش في التعب
اني رأيت وقوف الماء يفسده أن ساح طاب، وان لم يجر لم يطب
إلى آخر الآيات”.
وأسلوب وصفه يتوخى فيه الايجاز في أغلب الأحيان، ويرصد المشاهد الخارجية بصرف النظر عن انعكاسها في نفسه، كما في قوله يصف مدينة الإسكندرية[20] :” والمدينة من أحسن البلاد ترتيبا وبناء، وجدرانها بالحجر الأبيض المنجور، وسككها كلها على نسق نافذة متسعة”. ولكنه حين يشرف على الأماكن المقدسة يتبدل أسلوبه في الوصف حسب التأثير الذي تتركه في نفسه، من ذلك قوله في وصف المدينة المنورة[21]:” ثم صبيحة يوم الأربعاء وصلنا إلى المدينة المعظمة، ودخلنا الحرم الشريف، والمقام المنيف، وقد كساه المولى الجليل الهيبة والتعظيم، فأشرقت أنواره، ولاحت أسراره، وبرزت آثاره، فلا يخيل الخاطر تلك الأحوال، ولا تتعلق له تلك النفائس فيما قبل البال، فسلمنا عليه صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم، والنفس في دهش، والقلب في التهاب وعطش، فلا عليك أن ترى إلا داعيا أو سائلا أو راغبا متواضعا للمولى سبحانه وتعالى، متوسلا بحبيبه صلى الله عليه وسلم، ولله در القائل:
يا خير من دفنت في الترب أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم
أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلّت القدم
نفسي الفداء، لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم
وكما هو الشأن بالنسبة للرحلات السابقة الأخرى، فإن القلصادي يستخدم نظام التتابع الزمني لسرد رحلة الذهاب والإياب، وتقديم شيوخه حسب تاريخ اللقاء بهم، وما تمكن من الحصول عليه من الروايات والأسانيد، مع ما يتخلل ذلك التتابع مع صيغ التقطيع الواردة للكشف عن رؤيته.
لقد كتبت الرحلة في سياق سياسي وثقافي معين يتسم بتحولات لا يمكن تجاهلها ونحن نستنطق مشروعيتها الأدبية، فقد استولى الاسبان على كثير من البلاد الاندلسية وسيطروا على قرطبة ومرسية وطليطلة وسبتة وغيرها من المدن الاندلسية، وظلت غرناطة آخر المعاقل تعيش آخر أيامها خلال القرن التاسع الهجري. فقد كان الوجود العربي يتهدده الخطر الساحق في الاندلس. وتنادى العلماء والفقهاء والأدباء بصيحات الخطر، إلا أن كل التحذيرات التي انطلقت منذ سقوط بعض المعاقل لم تجد لها أذنا صاغية، فتهاوت البلاد شيئا فشيئا. على أن النشاط العلمي لم تخْب جذوته نهائيا، خاصة حين كانت مملكة غرناطة تلفظ أنفاسها الأخيرة، ففي هذه الفترة ظهر أعلام كبار مثل أبي عبد الله محمد السرقسطي وأبي الحسن علي القلصادي وغيرهما، واصلوا تزويد المكتبة العربية الإسلامية بالعديد من المصنفات في مختلف الميادين العملية والثقافية،. ومما يدل على هذا النشاط العلمي تواصل حركة التدريس والعطاء التي كانت سائدة. وقد كان القلصادي من المساهمين فيها خاصة بعد رجوعه من الرحلة حيث اشتغل بالتأليف والتدريس رغم أجواء الاضطراب والفتنة. وكانت رحلته من المصنفات الهامة التي استفاد منها عدد كبير ممن ترجم بعده لعلماء القرن التاسع الهجري كالمقري في نفح الطيب وأحمد بابا في نيل الابتهاج وابن مريم في البستان وغيرهم، كما ترجع أهميتها إلى أنها تُعدّ وثيقة من الوثائق التي تصور نشاط العلماء وطرقهم في التدريس والتعليم وكتبهم التي يتداولونها، وفنون المعرفة التي يطرقونها، وآدابهم عند التلقي[22]، فضلا على تلقي الضوء على مرحلة هامة من مراحل حياة القلصادي العلمية، وتكشف من خلال أسلوبها وصيغها التعبيرية وانفتاحها على خطابات معرفية وأدبية متنوعة على ملامح من شخصيته.
آمل أن
يكون هذا البحث قد حاول استنطاق نص سردي يوغل في التراث لتأكيد انتسابه الأدبي،
وهو غاية ما نتوخاه. رغم عدم زعمي أنني قد بلغت المنى في استيعاب هذا المتن
الرحلي، لكن يكفيني أني حاولت النبش في ذاكرة الموروث السردي العربي، وكل ما أطمح
إليه لفت الانتباه إلى مثل هذه النصوص التراثية وإعادة قراءتها قراءة جديدة.
[1] ـ رحلة القلصادي، دراسة وتحقيق: محمد أبو الأجفان، الشركة التونسية للتوزيع، 1978.
[2] ـ نسبة إلى مسقط رأسه “بسطة” الواقعة في الشمال الشرقي من غرناطة في الاندلس. وقد اختلف الباحثون في زمن ولادته ما بين 803 ه و 815ه. انظر رحلة القلصادي، المرجع السابق، ص31.
[3] ـ الرحلة/ ص 43 ، وأبو الحسن علي اللخمي القرباقي
[4] ـ انظر الرحلة، ص 162.
[5] ـ الرحلة، ص32.
[6] ـ الرحلة، ص115.
[7] ـ انظر الرحلة، ص 39.
[8] ، انظر الرحلة، ص38/39.
[9] – الرحلة: ص 81
[10] – المرجع نفسه.
[11] ـ سورة التوبة جزء من آية 122.
[12] ـ سورة آل عمران، آية 97.
[13] – الرحلة ص 168
[14] – الرحلة ص 89.
[15] – الرحلة: ص 97
[16] – الرحلة: ص 92
[17] – نفسه
[18] – انظر الرحلة: ص. 92-93
– الرحلة. ص 109[19]
– الرحلة: ص 125[20]
– الرحلة: ص 145[21]
[22] ـ الرحلة، ص73.