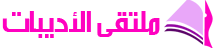جلست أم الخير تطل من نافذة بيتها، أو على الأصح، من أطلال بيتها. أشعة الشمس المتسللة بحياء من وراء غلالات من السحب تُشعرها بالدفء، كما تشعرها بحيوية تكاد تفتقدها. مسحت بيدها وجهها الشاحب، وعينيها المتورمتين من نضوب الدمع فيهما، وتطلعت للمرة العاشرة إلى الطريق. لقد تأخر عنها، وليس من عادته التأخر، بل كان دائما أول الحضور منذ احتضنته بين ذراعيها، ينثر حوله طاقات من المشاعر النديّة، يقبلها ويدغدغ عنقها حتى تكاد تسمع قههاتهما. يضع رأسه على صدرها حين يلفها الحزن والألم، يهمس في أذنها: “لا عليك حبيبتي، كل محطة من هذه المحطات التي نمرّ بها لن تزيدنا سوى التحدي والإصرار على مواصلة الجهاد، منذ ذكرى انتفاضة البراق في 17 يونيه مرورا بكل قطرة دم تروي أرضنا الحبيبة إلى الآن، ستظل خالدة في ذاكرة كل فلسطيني، بل في ذاكرة كل إنسان حرّ، وستقف شاهدة على بداية العدوان وعنفه، نستمدّ منها القوة والاستمرارية”.
كان حائط البراق جزءا من جدار المسجد الأقصى في القدس، وتقوم أمامه ساحة تابعة للأوقاف الإسلامية، وقد أُطلق عليه هذه الاسم لأنه الجدار الذي ربط به النبي محمد دابة البراق التي حملته من مكة إلى القدس، ومنها عرج إلى السماء. لذلك كانت له مكانة خاصة في قلوب كل المسلمين.
لن تنسى ما كان يرويه والدها عن انتفاضة البراق، فقد كان يذكر لها ولإخوتها كيف نظّم اليهود الذين استجلبتهم بريطانيا مظاهرة كبيرة في 14 غشت من 1929 بمناسبة ما أسموه ذكرى تدمير هيكل سليمان، أتبعوها في اليوم التالي بمظاهرة ضخمة في شوارع القدس، وتوقفوا عند حائط البراق، يرددون النشيد القومي الصهيوني ويشتمون المسلمين. كان جدّها ضمن مجموعة من الفلسطينيين الذين تأججت مشاعر المقاومة والجهاد في قلوبهم حين أدركوا نية الصهاينة للاستلاء على الحائط، فتوافدوا عليه ليحموه، ووقعت صدامات بين الطرفين، أدّت إلى اعتقال مجموعة من الفلسطينيين. وكان جدّها ثالت ثلاثة أعدموهم دون رحمة أو شفقة. لن تنس أم الخير أبدا الدموع المتلألئة في عيني والدها حين كان يقرّب إليهم مشهد الإعدام وما تلا ذلك من أحداث جسام، ما زالت تتراكم وتضفي على حياتهم مزيدا من العتمة والظلم، والصمود أيضا. كان مع أمه ومجموعة أخرى من النساء يراقب ما يجري دون أن يفقه شيئا، طنين الزغرودة التي أطلقتها أمه وسقوط والده على ركبتيه كأنه يتشهّد لم يبرحا أذنه وعينيه. شبّ مع أمه وإخوته الصغار وهو يرى تزايد عدد اليهود من حوله وتقليص أعداد الفلسطينيين بتهجيرهم قسرا أو بزجّهم في السجون. وحين انتهى الانتداب البريطاني سنة 1948، أعلنت العصابات الصهيونية، بتواطئ دولي، قيام إسرائيل وتنصيب غربي القدس عاصمة لها. ثم بعد العدوان الثلاثي في 1967تمّ احتلال الجولان وسيناء وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وكانت إسرائيل المحتلّة تأمل، ومَن مهّد لها من أهل الغرب والعرب، بتوطين الفلسطينيين في الدول العربية، وتحويلهم إلى جنسيات عربية تنسيهم وطنهم وحقوقهم، وتعينهم على الذوبان في المجتمعات التي كانوا يهاجرون إليها. استطاع مع أمه أن يصمدا في وجه التهجير، وحين أنشأ أسرته الصغيرة، أقسم ألا يهدأ ويظلّ يقاوم الاحتلال إلى آخر نفس.
لا تذكر أم الخير عدد المرات التي سُجن فيها والدها بتهم مختلفة، أبرزها قيامه بأنشطة أمنية ضد إسرائيل، إلى أن جاء خبر استشهاده داخل السجن في السنة نفسها التي تزوجت ابن رفيقه في الجهاد. كان زوجها قد انضم إلى المقاومة الفلسطينية، ووصل إلى مراكز عليا فيها، ولم تعد تراه إلا نادرا وبشكل خفي. وحين وصلها خبر استشهاده في حرب أكتوبر، بعد فتح المقاومة جبهات ضد الاحتلال داخل الأراضي المحتلة، كانت قد أنجبت منه خمسة من الأبناء، ثلاثة من الذكور واثنين من الإناث. كانت حياتها كأي أسرة فلسطينية داخل القدس، وداخل الأراضي المحتلة عموما، تناضل من أجل مجابهة شتى المضايقات التي تتخذ أشكالا مختلفة، ابتداء من سياسة الإفقار والمنع من العمل، وفرض تدريس المناهج والمقررات الإسرائيلية للأبناء المتمدرسين في ظل تدهور مدارس الأوقاف الإسلامية وحالاتها المزرية، مرورا بفرض ما يُسمى بوثيقة الإقامة الدائمة التي يمكن أن تُسحب من المقدسي في أي وقت إذا لم يستطع إثبات أنه موجود في القدس باستمرار، ويدفع الضرائب المتنوعة بانتظام.
الأبنة الكبرى لأم الخير خولة دخلت السجن في سن مبكرة لمشاركتها الاحتجاج ضد الاحتلال الإسرائيلي. ذاقت أصنافا من التعذيب والإهانة منذ اللحظات الأولى للاعتقال، فقد تمّ ربطها في أوضاع مجهدة، وتعرّضت أكثر من مرة للضرب والركل في أنحاء جسدها، مع الكثير من السباب والتلفظ بتعابير جنسية بذيئة. وعلى الرغم من أنها لم تسجن بعد ذلك إلا أنها ظلت لسنين طويلة تتعرض لنوبات من ضيق التنفس والشعور بالاختناق في الأماكن المغلقة. ولم تعمل إلا بعد أن اضطرت إلى ذلك، حيث أصبحت تعيل أسرتها، لأن زوجها أصيب في عموده الفقري، حين حاول أن يسعف ولده في انتفاضة الحجارة الأولى في 1987، التي انطلقت إثر صدام شاحنة إسرائيلية عمداً لسيارتين فلسطينيتين كانتا تقلان عمالاً من مخيم جباليا في قطاع غزة. وأسفر الحادث عن مقتل أربعة فلسطينيين وجرح تسعة آخرين من ركاب السيارتين مما أثار سكان المخيم الذين خرجوا إلى الشوارع يرشقون جنود الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة. وانتشرت التظاهرات المعادية للاحتلال في جميع أراضي قطاع غزة والضفة الغربية، وامتدت داخل القدس وشرقها. وكانت وطأة شديدة على المحتل، ازداد فيها سعاره، فأخذ يقتل ويأسر لمجرد الشبهة. كان ابن خولة البكر الذي لا يتجاوز السبعة سنة من عمره مارا مع والده أمام مجموعة من الجنود الإسرائيلين حين أوقفوهما للتفتيش. بدأ أحد الجنود يفتش الولد بعنف، حاول الوالد أن يذوذ عنه فدفعه الجندي وصفعه، فما كان من الإبن إلا أن بصق عليه. وبسرعة صوّب جندي آخر رشاشته وأطلقها على الولد، فأرداه شهيدا. هوى الوالد المفجوع على ركبتيه يحضن ولده، فتلقى رصاصة في عموده الفقري، تركته مقعدا طول الحياة، ومنذ ذلك الوقت أصبح على خولة أن تكون العائل الوحيد لأسرتها، إضافة إلى تمريض زوجها.
الأبنة الثانية لأم الخير بيسان كانت تشتغل مدرسة في إحدى مدارس جنين، اختطت لنفسها مفهوما خاصا لكيفية التدريس، يراعي ما يتعرض له الأطفال في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وانعكاس الأوضاع الأمنية الحرجة على نفسياتهم وتصرفاتهم. وحين طبّق شارون ضمن خطته الاستيطانية في الضفة الغربية مشروع جدار الفصل الصهيوني، كانت بيسان أمام خيارين: إما أن ترجع إلى أسرتها في القدس وتبحث من جديد عن عمل قد يبعدها عن العملية التربوية التي تقوم بها أثناء التدريس أو تستقر نهائيا في قرية برطعة في ضواحي جنين. وقد اختارت الخيار الثاني رغم قسوته، لتذوق مرارة البعد عن أمها وإخوتها، وانخراطها بقوة في معاناة الحواجز والبوابات واعتداءات المستوطنين الصهاينة على الطرق. وقد سجلت بيسان في مذكراتها التي دفعتها إلى صحفية ألمانية ما يتعرض له الطلبة والمدرسين من اعتداء مباشر بالضرب أو الدهس أو إطلاق النار من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين، إضافة إلى سلسلة من الانتهاكات الحقوقية للإنسان بصفة عامة. فذكرت أنها حضرت شخصيا استشهاد إحدى الطالبات وهي تسير بمحاذاة جدار الفصل العنصري بعد إصابتها برصاصة مطاطية. فضلا عن معاناة تسجيل بصمة كل من الطلبة والمعلمين الذين يمرون عبر الجدار بشكل يومي، خاصة إذا تمّ خلق أعذار عدم مطابقة البصمة، ليقع تحويلهم إلى مركز الإدارة المدنية في حاجز سالم القريب من جنين، ويتأخرون عن الوصول إلى المدرسة أثناء ذلك. إضافة إلى التعمد في تأخير إصدار التصاريح، وانتهاء مفعولها قبل انتهاء العام الدراسي. وأكدت خولة في مذكراتها أنها تغيبت أكثر من مرة بسبب تأخير صدور التصريح لها. وفي خضمّ هذه المعاناة اليومية تعرفت على زوجها، وأنجبت أطفالها الثلاثة.
طال انتظار أم الخير لابنها الصغير إياد ، لا شك أن حدثا جسيما أخره عن المجيء، حرصت دائما أن تجتمع العائلة كلها في 17 يونيه من كل سنة، يسترجعون أهم الأحداث التي عاش في ظلها وطنهم السليب. ولا تسمح بتخلف أحد إلا إذا كان مضطرا، ومع ذلك ظل عددهم ينقص كل سنة بسبب ظروف قاهرة. هذه السنة لن يأتي سوى إياد. ابنها البكر مصعب رحّلوه قسرا مع أبنائه خارج البلاد، بعد سلسلة من الاستدعاءات تطالبه بالحضور إلى مقر المخابرات للتحقيق معه حين نشر عددا من المقالات في مجلة “العودة المقدسية” المحاصرة. وبعد نشره لقصيدة “الاتحاد القادم” في المجلة، ألغوا ترخيص المجلة، وأعادوا استدعاءه. كان يقطع السياج تلو الآخر صباحا، ثم يدفعونه داخل غرفة ضيقة مظلمة، لا يوجد فيها سوى مقعد مهترئ، ويظل ينتظر إلى أن يحلّ المساء دون أن يمثل أمام أي أحد، ثم يأتيه أحد الجنود ليطلب منه أن يعود في اليوم التالي في الموعد نفسه.. كانت تنتابه لحظات الغضب، لكن أمه تهدئه، وتقول له: “إنه استفزاز منظم كي يخرجونك عن طورك وتتصرف أقل تصرف ضدهم فيعتقلونك، كلماتك أشدّ وقعا وتأثيرا من أسرك بني، تشحذ الهمم وتعيد الأمل في مواصلة الجهاد”. ظل على ذلك الأمر أكثر من شهر، قبل أن يخبروه بواسطة جندي شاهرا بندقيته في وجهه بأنه مطرود من البلاد لأسباب أمنية، ويُمنع عودته مطلقا. كان وقع النفي مزلزلا على كل العائلة، ودّ لو يقوم بعملية استشهادية داخل أقرب مستوطنة، لكن جاءت الأوامر من الكتيبة التي ينتمي إليها بأن يمتثل، ويلتحق بالأردن للعمل في إحدى الجرائد هناك، وأن يكثّف من كتاباته في كل موقع يُتاح له. لم يكن له خيار آخر سوى أن يعيش منفاه، ويوجّه طاقاته على هذا الأساس، فلا شك أن الرحلة ما زالت طويلة، والمقاومة لها أوجه عدّة، ورغم التشرّد والتشتت في البلدان، فإن عنفوان الكلمة الصادقة بذرة تنمو وتؤتي أكلها في كل مكان. كان الأمر شديدا عليه، فقد حُكم عليه ألا يرى عائلته، ولم يُسمح له باستخراج أي تصريح زيارة التي أجازتها السياسة العسكرية الاستعمارية لبعض اللاجئين كي يزورا عائلاتهم لمدة شهر، ثم يعودوا إلى خارج البلاد. ومع علمه أن هذه سياسة خبيثة كي يقطع اللاجئون والمنفيون أي أمل في العودة نهائيا، إلا أنه لم يتوان عن محاولة استخراج التصريح، لكن دون فائدة. ومع مرور الوقت ظل حلم العودة مستحيلا، خاصة في ظل سلسلة من الهزائم والإحباطات والانتكاسات من طرف أبناء الأمة، وتحول الحلم إلى كابوس يهيمن على الواقع المشوّه.
ابن أم الخير الآخر عبد الله، ذاق مرارة السجون الإسرائيلية في سن مبكرة. كان عمره لم يتجاوز السادسة عشر حين سُجن لأول مرة بتهمة حيازة الحجارة. أما بعد ذلك فكانت التهمة الجاهزة هي التحريض وإحداث الشغب والعنف. والحقيقة أن عبد الله لم يتخلّف عن أي انتفاضة من انتفاضات الأقصى. لقد فاجأت ما أسموها ب “انتفاضة الأقصى” العدوَّ الصهيوني بقدر ما أربكت سلطة الحكم الإداري الذاتي المحدود. وجاءت مثل هذه الانتفاضات التي حرص عبد الله وغيره من المرابطين المشاركة فيها، مغايرة لكل الحسابات والتوقعات الصهيونية و”السلطوية”. بل انبثقت ريحا مقاوِمة، تسير عكس الرياح العاتية التي تضرب المنطقة منذ سنوات، والتي أغرقت الدول العربية المتاخمة لكيان العدو باضطرابات عسكرية طاحنة ومستوردة، ووجّهت اهتمام الشارع العربي ومجتمعه قصدا، بعيداً عن القضية الفلسطينية، قضية الأمة المركزية، وغيَّرت طبيعة السياسات والتحالفات العربية والإقليمية، احتلّت القضية الفلسطينية أسفل مراتب الاهتمام، وأخرجت الدول العربية المتحكمة بناصية القرار في جامعة الدول العربية، العدو الصهيوني من دائرة العداء، وفتحت أبواب التطبيع والتنسيق معه بذريعة محاربة الإرهاب.
كانت لعبد الله مهمات جليلة وخطيرة في انتفاضات الأقصى، لكن دون أن يترك خلفه أي دليل أو إثبات. لذلك حين يعتقلونه بعد كل عملية من العمليات التي يقوم بها أبطال فلسطين، يكون أول المشتبهين فيه. وتسبق عملية الاعتقال مداهمة بيته بطريقة استفزازية، يقع فيها تحطيم كل ما يصادفه الجنود أمامهم من أثاث، وإهانة كل من يوجد في البيت من النساء والأطفال وضربهم، وإطلاق الرصاص للترهيب وزرع الخوف في النفوس.
في آخر اعتقال، كان الوقت فجرا، عبد الله يستعدّ للوضوء حين سمع صوت أقدام ثقيلة تتجه نحو البيت، الباب يئن تحت ضرباتهم إلى أن يرتمي أرضا، ينتشر الجنود في أنحاء البيت يفتشون، يصرخون، يسبون، يلعنون. الصراخ يشتد، وسيل من الأسئلة تتناسل بعنف. يجرون عبد الله جرا لما يتهالك جسده من الضرب، ليرمونه في الشاحنة العسكرية. وهو يتدحرج بين أرجل الجنود في الشاحنة، تمنى أن يستلمه التحقيق مباشرة، لأن ذلك يجنبه التعليق بالسلاسل الحديدية والسياط بالقنب المضفور المبلل كل لحظة، أو الوقوف ساعات طويلة على قدم واحدة دون حركة، وإذا تحرك، تعرض للصفع والركل. حين وصلوا إلى المعتقل وضعوا القيد الثقيل في يديه وقدميه، وسلموه إلى أحد المحققين. أول ما يبدأ المحقق أسئلته بصفعة مدوية يتحوّل فيها وجه عبد الله، ويظل متخشبا من الألم، لا يستطيع أن يديره إلا بعد مرور لحظات. ثم يسأله عن اسمه، وحين يجيبه يقفز المحقق قفزة في الهواء ويسقط رجله على بطن عبد الله بركلة قوية تطيح به على ظهره. ولا يتركه يستجمع نفسه، بل تتكرر العملية مع كل سؤال. وحين يتعب المحقق، يعقب سؤاله بإطفاء سيجارته في أي موضع من جسد عبد الله، وإطلاق شحنات كهربائية فيه. وبعد هذا الاستقبال الرسمي، يدفعونه نحو زنزانة منخفضة السقف، ممتلئة بمعتقلين آخرين.
اجتاحت أم الخير نغزة في صدرها وهي تستعرض مسير تاريخ طويل، شاركت فيه عائلتها بمختلف ألوان مقاومة الاحتلال، وأشدّ ما يؤلمها أن ريح هذه المقاومة بدأت تهدأ، ولم تعد تسمع أصداءها، خاصة خارج فلسطين، وانشغل كلّ عضو من أعضاء الأمة بذاته. طلعت تنهيدة حرّى منها، وحرّكت كرسيها لتلتصق أكثر بالنافذة، تطلعت نحو الطريق. الزقاق الممتد أمامها يكاد يخلو من المارة، ولا أثر بعد لإياد. كانت تعرف أنه أصبح أحد القياديين الذين يبتكرون وسائل وأدوات المقاومة في القدس، ويديرون عملياتها. وكانت تخاف أن يستشهد قبل أن ترى أبناءه يحملون مشعل المقاومة والجهاد. قررت هذا اليوم أن تفاتحه بضرورة مراجعة الطبيب للنظر في سبب تأخره في الإنجاب. لا تدري ماذا ينتظر، كل ما هي متأكدة منه، أنه رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون داخل وطنهم المحتل، إلا أن هذا لا يمنع من التوالد والتكاثر، لذلك تردد لكل من حولها حين يدور الحديث حول هذا الموضوع: “لا تسمحوا لهم بإبادتنا، كل مولود بمثابة طاقة جديدة، تفتح أمامنا أبواب أمل حقيقي لاسترجاع أراضينا وذاكرتنا المغتصبة”.
شاهدت أم الخير إياد يتسلل إلى المنزل مترقبا. احتضنته بقوة:
ـ “خشيت أن تذهب في مهمة ولا أراك”
ـ “ما كنت لأتخلّف عن موعدنا”
أضاف وهو يتشبث بعنقها كطفل صغير: “أين كنت سأتزود بمثل هذه الابتسامة المشرقة التي تنير لي دربي؟”
قالت بصوت خافت: “يزداد الظلام كثافة من حولنا يا بني، لشدّ ما أخشى أن يتحوّل زمن الاحتلال الخيالي إلى زمن واقعي، وزمننا يكاد يكون متخيّلا، يصبح مجرّد ذكرى تضمحلّ يوما بعد يوم، أو حنين تكاد تنمحي ألوانه، أن يكون النصر مجرّد..”
وضع أصبعه على فمها المرتعش ولم يدعها تكمل:
ـ “كلما اشتدّ الظلام وانتشر يقع انفراج بإذن الله وينبلج صبح جديد، مهمتنا أن نثبت ونقاوم بكل ما نملكه من نفَس، انتصارنا رهين بالصمود وعدم الاستسلام..”
اغرورقت عيناها بالدموع حين قام يودعها، قال بأنه قد يغيب مدة طويلة عنها هذه المرة، وما عليها سوى الدعاء، وأضاف بمرح:
ـ “أبشرك أمي أن زوجتي حامل بتوأمين..”. قبّل رأسها وتسلّل مترقبا كما جاء، تاركا في قلبها أمل جديد يتبرعم.