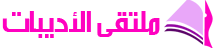حين اتصلت بي الشاعرة الرقيقة فاطمة بنيس وطلبت مني تقديم شهادة في حق شاعرتنا مليكة العاصمي لم أتردد لحظة واحدة رغم كثرة الالتزامات وضغوطاتها، ووافقت على الفور. لكن حين خلوت إلى نفسي، أدركت حجم الورطة الجميلة التي وضعت نفسي فيها، فأن تقدم شهادة في حق إنسان ما، فهذا يعني أنك تعرفه شخصيا، فما بالكم بالشاعرة مليكة العاصمي؟ وأنا لم يسعدني الحظ باللقاء مع شاعرتنا إلا اليوم، رغم أنني قارئة بامتياز لها، أغوص في جداولها كلما انسابت بين خمائل المشهد الشعري.. ورجعت إلى ما كتبته عنها، منذ أكثر من 16 سنة، كنت آنذاك متدثرة بوهج الاندفاع، ولم تكن هناك رحابة تتسع لرحابة كونية إنسانية، فكانت رؤيتي لشعرها آنذاك ينحصر فيما يُظهر من دلالات، لا ما يخفي.. ولعل هذه الكلمة تعيد اكتشافي للدلالات الخفية، وتتبرعم في فيوضات شعر، تألقت صبواته البهية كلما أبصرته يوغل في معارج الروح، ويسيح في وهج إعادة صياغة العالم مع كل قصيدة، بل كل صورة، وشتان بين الرؤية والبصيرة.
وأرجع بكم إلى البدايات الأولى للشعر النسائي في المغرب، وريادة الشاعرة مليكة له فأقول، إن المرأة بما أودعه الله فيها من عواطف الرقة والحنان والحب هي في حد ذاتها قصيدة شعر رائعة، تزيد من روعتها لو تغلغلت في الفهم, وألقي إليها السمع. وقد استطاعت المرأة المغربية الشاعرة أن تجد مكانا لها في فضاءات الشعر بمختلف اتجاهاته, وتعبر بصوتها عن كل ما يختلج في ذاتها, ما دامت قد أعلنت رفض الصمت. لذا نجد أمامنا متنا شعريا حاضرا بقوة، يبوح بصيغة المؤنث وفتنته، ويوغل في الوجدان الخصب، كما ينفتح على قضايا ومواضيع تتأمل الذات، كما تتأمل الواقع. وكما هو الشأن في الأجناس الأدبية الأخرى كالرواية والقصة القصيرة، فقد تأخر ظهور إصدار أول مجموعة شعرية نسائية بالمغرب إلى 1975 ، حيث أصدرت فاطمة بن عدو الإدريسي ديوانها الأول أصداء من الألم، وبذلك يكون صدور أول مجموعة شعرية نسائية متأخر عن أول مجموعة شعرية رجالية في المغرب، {حيث صدرت سنة 1963 لعبد القادر حسن بعنوان أحلام الفجر}. وصدرت المجموعة الشعرية النسائية الثانية بعد ذلك في 1979 بعنوان دعني أقول لسعاد فتاح، ثم انتظر الشعر النسائي فترة الثمانينات ليشهد طفرة كمية نوعا ما، حيث صدرت سبع مجموعات شعرية، ديوان أهددك بالحياة وديوان شعلة تحت الثلوج لفاطمة بن عدو الإدريسي وديوان لعبة اللانهاية وفصول من موعد الجمر لسعاد الناصر، وديوان فجر الميلاد لآسية الهاشمي البلغيثي، وديوان كتابات خارج أسوار العالم وأصوات حنجرة ميتة لمالكة العاصمي. طبعا هذا بالنسبة للدواوين المطبوعة، وإلا فإن لشاعرتنا فضاء رياديا متميزا على أعمدة الصحافة قبل ذلك. ثم توالت الإصدارات في تسعينات القرن الماضي إلى الآن، وتألقت أسماء وتجارب استطاعت أن تخلق تراكما نوعيا ملحوظا. ولعل إحصاء بعض الأصوات التي غردت بملء فيها بكثير من العشق والإقبال, على الرغم من التهيب والمعاناة,يكشف في مجمله عن غنى وخصوبة الينابيع التي سقت تلك التجارب، ومنحت كل واحدة منها تميزها وخصوصيتها.
ومع أن التجربة الشعرية النسائية عموما, ما زالت في بدايتها, تحلق في أفق مفتوح وطموح, وتبحث عن جذور لها في حركية متنامية ومتطورة، إلا أن أهم ما يميزها هو الاغتراف من الذات الأنثوية، ومعايشة اليومي ومشكلاته في حياتهن، دون إغفال لواقع فاقد لتوازناته الثقافية والاجتماعية والسياسية.
وهكذا انبثقت مليكة العاصمي من رحم البدايات والتحولات الاجتماعية والثقافية، في مغرب السبعينات والثمانينات، لتعلن أن المرأة المغربية قادرة على الريادة والتجدد والخروج من نفق الصمت، وشرنقة التهميش، لتتدفق شجية، تؤسس كونها الشعري، في فرادة، تغازل فضاءات البوح الباذخ، فيتدفق رذاذا ناعما، وصيبا هتونا.
تقول الشاعرة مليكة في تغلغلها الأنثوي داخل ذاتها:
تفتح فلقُ الإصباحِ تفتّحتُ،، وفجّرني خيطٌ ذهبيُّ غازلني،، وتبرْعم في نوّارتيَ الصفراء،، فتَّحْتُ بذوري،، نوَيَاتِيَ ونُذُوري،، فتَّحْتُ دَواخِلَ رُوحي في وَهَجِ الإشْعاعْ،، نَزَعْتُ خُدورِي،، خَلْخَلْتُ جُذُوري،، وَاسْتَكْمَلْتُ لمَصِّ النَّارْ،، جَسَداً حلَّ مَسَارِبَهُ لِتَلَقِّي نَضْحِ الشَّمْسِ اللاَّهِبَةِ اللَّهْفَى.
وتنفتح شاعرتنا على الواقع، فيخيب أملُها في بعض اللحظات الشاعرية، في المثقفين من حملة المشاعل ونافخي الأبواق وقارعي الطبول، ممن يتهافتون على الخنوع والركوع حتى يفقدوا إنسانيتهم، ويمسوا مطية للأسياد تحمل الأَوزار، وما أكثرهم في هذا الزمن المغبر، فتقول:
داء ينتشر،، داء التّحامر،، ينفثه المريض في النهيق،، أعراضه: أن يتبلّد الإحساس،، ثم تموت النظرة الحنونه،، وتستطيل الآذان،، وينبت الشّعر على الجلود،، ثم يصير الشخص من فصيلة الحمير،، يليق للركوب،، يحمل أثقال السادة الكبار، يظل خانعا، و ظهره مطيّة للآخرين،، وينقل التراب و الحجر،، والجير والمتاع… لهفي عليك أيها الشعب الحزين،، يعمّ داء العصر،، يقتل كلّ إنسان بهذا العصر،- قصيدة “الوباء”، ص 40 – 41
وتجوب قضايا الواقع العربي فتقول: أمامكَ، يمتشق النخل حساماً في بابلْ،، تتجلل أشجار الأَرز مناطيداً في بيروتْ،، يتعالى السرد بأرض القدس، ويقذف ألسنةَ،، حرابٍ مسنونهْ،، أمامكَ، يحمل نهر النيل وبردى،، ترتجّ مشارف صحراء المغربِ،، تهتز الكثبانُ،، وتصفع وجه النسمات المسكونة بالأرباح.
وبما أن للشعر غواياته الخاصة، فقد سكنت القصيدة مليكة وسكنتها، وظلت وفية لتوهجها، تبحث عن نبضاتها المتفردة، عن انسيابها في سطح الواقع تمحو ما يشوبه من قبح وتشوه، تقول : غيّرتُ اسمي منذ حينٍ،، حينما العواصفْ،، تقذِفُ الأغصانَ للأغصانِ،
حينما الرياح،، تسوقُ من فوقِ المحيطِ كُتلةَ السُّحُبْ،، لتنزح الأحزان من فوق الزهورْ،، سمّيتُ نفسي كالمياه تُنظِّف الأغصان والشجرْ،، وتكنس الأدران في القلوبِ،، والثياب والحجرْ،، قَرَّرتُ أن أُدعى: مطرْ’.
كثيرة هي انشغالات القصيدة عند شاعرتنا، تتوزع عبر محاور رؤيوية متعددة كما رأينا، تغرف من ذاتها الأنثوية لتصب في بحار الوجود، تعانق جراحات الذات والوطن والأمة بإبداع شفيف، يحتمل دلالات خصبة، مفعمة بالصدق والتمرد والنصاعة، والألق الشعري ومائه أيضا. في واقع شعري، يكاد ماؤه يجف من كثرة الوحل الرؤيوي والضعف اللغوي. أحيي شاعرتنا الرقيقة المتألقة في شعرها وحضورها الباذخ. وأختم بقولة لأستاذنا د. نجيب العوفي قالها في ندوة تجليات المرأة في الخطاب الشعري المغربي الذي نظمتها فرقة البحث في الإبداع النسائي بكلية الآداب بتطوان، “التيار النسائي في طريقه إلى تأنيث العالم” وأقول: في خضم تيارات العنف المتنامية يوما بعد يوم، ما أحوج العالم فعلا لرقة الأنثى، ولروح الشعر.مساؤكم شعر ومحبة.