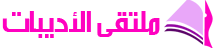في حياة كل إنسان مجموعة من النجوم المضيئة التي يستلهم منها ما يعينه على الاستمرارية والمضي في طريقه، وسط عالم يكاد دخان ظلامه أن يخنق السائر فيه، وعبد اللطيف شهبون من القلائل الذين يُمدّون مَن حولهم بأنفاس التحفيز والاستمرارية لا يكدر صفوها أي عاصفة أو حصار، ودون كلل أو التفاتة إلى العراقيل المطروحة آنا بعد آن، فيحضر في ذوات المتواصلين معه كل حين. لذا ليس من السهل الحديث عمّن تجمعت فيه شمائل تفرقت في غيره، فهو صعب بقدر ما هو ممتع، وبسيط بقدر ما هو عميق، لأنه سنديانة إنسانية وعلمية شامخة، وبحر خِضمٌّ لا تسأل عن صدفاته. وهذه الأوصاف ليست مبالغة أو بلاغة رحبة وإنما هي توصيف صادق لما أشعر به كلما التقيت د.عبد اللطيف شهبون في الحضور وفي الغياب.
التقيت بالدكتور عبد اللطيف شهبون برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جمعتنا علاقة الزمالة العلمية والتربوية، لكني حين أسترجع الأساتذة الذين تتلمذت على أيديهم، وتأثرت بهم أراه بينهم، يطالعني وجهه البشوش، وأجدني نهلتُ من معين حصصه التكوينية المفعمة بالمعرفة والارتقاء الروحي والنقاش الجاد الممتزج بالكثير من المحبة والمرح، في مختلف مجالات الأدب والحياة. فأدرك أنه وُفّق في تكوين نهج تواصلي، يمكن أن يُعدّ مدرسة علمية وأدبية وأخلاقية، عمل على إرساء قواعدها بالكثير من نكران الذات، ووافر الارتقاء والرقي. تخرّج منها عدد وفير، صاحبهم الدكتور عبد اللطيف معلما موجها، وباحثا مقتدرا. فقد سلك شعاب الدرس الأدبي والصوفي باقتدار وتميز، وأشرف على بنيات ووحدات ورسائل وأطاريح جامعية متنوعة، كانت من دعائمها الأساسية الاعتزاز بالهوية الوطنية والروحية. وطبَع مرحلة من أهم مراحل كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان ببصمته الخاصة، رغم ما لها وما عليها، حتى ليكاد يُعدّ نسيج وحده، الأمر الذي أدرك من معه وحوله أنها دليل تصالحه مع ذاته وارتقائه بها نحو مقامات البذل والإبداع. فهو مسكون بقضايا طلبته وحقوقهم، يشاركهم معاناتهم وهمومهم بحس أبوي نادر، يجب تنبيه الغافلين إلى دلالاته وعمقه الإنساني والتربوي، ويعزز نشر المعرفة والعرفان بين هؤلاء الطلبة، أو لأقول المريدين، إضافة إلى مراهنته على اختياراتهم وتعزيزها، وعلى الجميل القادم، رغم قساوة الحاضر وبؤسه، فيشتدّ أزرهم الروحي، ويخفف عنهم وعثاء الطريق ونصبه.
وأُدرك أن الأجمل الذي كان دائما يثير في نفسي الدهشة وأنا أتأمل اللحظات الكثيرة التي جمعتني بعبد اللطيف شهبون، عمقَ رؤيته ودقتها ورؤيا بصيرته وشفافيتها، وتمازج هذا وذاك في أبحاثه ومشاركاته العلمية، وفي شعره ومقالاته الإبداعية، وحسن امتلاكه لتحويل الكلمات نحو دلالات تتداخل فيها سلطة المعرفة بطقوس المتعة واللذة، وتتوغل في قدرته على ترسيخ القيم الروحية والأخلاقية، في كل مرفئ من مرافئ حياته، سواء في شفشاون موطن الأصل، أم في تطوان مسقط قلبه وفضاء حبّه الأول وملهمة مواجده وأشواقه، أم في طنجة مانحة الصحبة الخيّرة ومجدّدة اخضراره. لتتدفّق في كل المرافئ معين تجربته المضمخة بالمكابدة والمجاهدة والوجد والعشق والاحتراق.
فلقد عركته الحياة بما فيها الجامعة والأدب، وتعلم من درسها ما وقفنا على جانب منه. لكن الذي يُجلّي شخصيته العلمية والإبداعية، إضافة إلى مسيره الأكاديمي والحقوقي، مجموعة من الدواوين الشعرية تشتعل حدوسا وإشراقات، تكشف عن دواخله الأليفة، وعن عوالمه المستوطنة في البوح والكشف، والصحو والسكر. والتي تنصهر فيها منعطفات راكمت توهّجا غريزا، انبثق منذ انكتاب ثلاثيته “كما لو رآني” و”ذاتي رأيت” و”إليك انتهيت” التي ابتدأت بالرؤية وارتباط الذات بها، وانتهت إلى القرب والفناء والتماهي في الذات الإلهية:
“وضعت قدمي
طريق ندمي،
كنست كل شيء..
فراشي لا إلاه
وجده
لا شريك”[1].
والمتأمل لدواوينه كلها يجدها تنبض بالذوق، وتغترف من مقامات السلوك والمحبة، عبر تجربة حية من عمق الأنوار الصوفية. فهو شعر “يحدثك عن التصوف من داخل تجربة الشاعر الصوفية، ويدلُّك على مكابداته، ويكشف لك عن نبض الروح، ويحدثك عن سجدة وتسبيح، ومحبة، وتوبة، وفناء، بعد أن شرب مما سُقي”[2]. فالشاعر يسكن فعلا ومتخيّلا في أفق صوفي، تنطلق مقاماته ومعارجه من الذات الفردية لتمتد في الوجود، وتتصل بالمطلق وتفنى فيه، بعد معاناة مثقلة بحزن الخطايا والذنوب:
“ليس في الوقت متسع للرثاء..
وما لا تطيق الحروف
ليس في الوقت متسع للبيان
وقد لاح من شرفة الروح حيْن
تسلل من خلل العمر..
يسألني..
ثم يسألني عن رواح؟
أبوء بكل الخطايا..
بكل الذنوب..
وألمح ذاتي هلامية
في فضاء![3]“
والانبثاق من اللحظات الصوفية المعيشة تتجلى في معظم نصوصه، فالروح في بحث مستمر، تتراوح بين إشراقات الوجود الشعري والوجود الواقعي، لتتجسد في نصوص تكتنز دقة في التصوير وتدفقا في المشاعر، فتلبس الكلمات ذات الشاعر ويلبسها، ويسبح في يمّ العشق، ثم يذوب في محراب الانتظار:
“شط المزار..
لا الليلَ أُدرك لا النهار..
يا روْح روحي
يا هزار:
الليل يسكنني..
ويُفنيني انتظار”[4].
وكثيرة هي النصوص والصور واللحظات التي تشكل في مجملها صورة للدكتور عبد
اللطيف شهبون الإنسان والأكاديمي الباحث والحقوقي والشاعر، لكن الميسم الذي يسمها
هو سمة الوفاء الجميل. وهي لعمري سمة نادرة في عالم يضجّ بالنكران والقبح، ولا
يصحّ فيه سوى ملازمة مَن “لم يزل يراك” في سرك وفي العلن. فهنيئا لنا
بهذه القامة الرفيعة التي صاحبناها، وانسابت نفحاتها وقبساتها في ذواتنا خصبة
ندية، مفعمة بالعمق الروحي والمعرفي.
[1] ـ ديوان إليك انتهيت، منشورات سليكي إخوان، طنجة، 2010، ص40.
[2] ـ من مقدمة محمد الحافظ الروسي لديوان غدا تلقاه، منشورات سليكي إخوان، طنجة، 2015، ص4.
[3] ـ ديوان إليك انتهيت، مرجع سابق، ص22.
[4] ـ ديوان كما لو رأني، منشورات سليكي إخوان، طنجة، ص26.