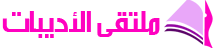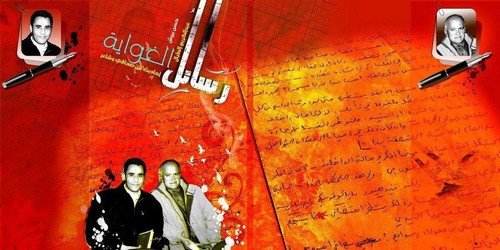من الرائع أن نفسح فضاءات متجددة لجنس أدبي، كان يشكل رافدا مهما من روافد تراثنا الأدبي، وكان له حضور مؤثر في الكشف عن جوانب جمالية في هذا التراث، منذ عبد الحميد الكاتب والجاحظ والتوحيدي، مرورا بجبران ومي زيادة والرافعي وغيرهم ممن أنصتوا لخلجات الروح، وتجاوبوا مع مكامن النفس الإنسانية، فأبدعوا رسائل عبرت عن إشراقات متوثبة من الذاكرة، متماوجة مع حبر القلوب، حتى غدت مراجع إبداعية شاهدة على التألق والبيان والسمو مثل “رسائل الغواية”. إلا أن عوامل عديدة تساهم في عصرنا على تلاشي هذا الفن الجميل لعل أهمها حمى التواصل الآلي والسريع الذي بدأ يتسرب إلى علاقاتنا مع من نحب، وحمى الاشتغالات اليومية التي تفرض إيقاعا سريعا لا يكاد الانسان يجد معه الوقت لتسطير رسالة، تعبر عن مكنونات القلب والوجدان، وتأملات العقل والفكر.
وقد كان المبدع حسن بيريش موفقا حين حرص على ضخ دماء جديدة ومتميزة في جسد هذا الجنس، كما حرص على الإنصات لنبضات روحه وهي تتجاوب مع نبضات روح عاشقة للإبداع والجمال، علمته كيف يجعل “من الإنصات الممتع الى الأشياء اللصيقة بالروح حبرا للرسائل”.وكانت النتيجة أن ربح القارئ رسائل ممتعة تعزف على أوتار إعجاب وتقدير ومحبة بين علم متميز من أعلام الشعر العربي هو عبد الكريم الطبال، وأديب شاب تملكته جمالية التعبير فامتلك ناصيتها هو حسن بيريش.
ومنذ ولوجنا عتبات هذا البوح الجميل تواجهنا الكلمة المغموسة في ألق الشعر وروعة البلاغة، وتفتننا بصدق الشعار الذي آمنت به:
“اللغة التي لا تتوضأ بماء الشعر، وتكتفي بالتيمم النثري البارد: تنتج رسائل مشكوكا في خشوع صلاتها”.
وينخرط القارئ في متون بوح شاعري، يتخطى الزمان والمكان نحو عوالم تكشف عن جوانب هامة من شخصية الكاتبين، ومما يتفاعل فيها من اهتمامات وهموم ثقافية وإنسانية مشتركة، تخلدها الكتابة:
“إن ما يبقى منا في النهاية، هو تلك اللحظات التي نحاور فيها مناطق خاصة في ذواتنا. كل شيئ يتهاوى، يتسرب، وحدها الكتابة تحظى بالخلود، بالديمومة”.
فنجد شخصية حسن بيريش المفعمة بالود والدهشة والافتتان، نغوص في صورها المتنوعة المتكاملة: منها صور الذات المثقفة، المتعانقة مع أعلام وقمم ونماذج أدبية، يرسمها بيراعه مثل صورة حسن المتزود بإبداعات مختلفة ومتنوعة :
“أكتب لك من مقهى شاطئي أحب الجلوس فيه خلال رمضان, أمامي البحر مزروع بالأضواء، وعلى الطاولة رواية {المحاكمة} للكويتية ليلى العثمان، وسيرة محمد أنور السادات {البحث عن الذات} وكتاب {بلند الحبدري اغتراب الورد}لمجموعة من الكتاب. أحس رغبة عارمة في القراءة هذا الشهر المبارك، رغبة يبدو أنها لن تدع فرصة لكتابة الكثير من المشاريع الأدبية والنقدية التي أحلم بها”
ومنها صور التماهي مع هذه الشخصية تنعكس صافية على مرآة روح الطبال الشفافة في مثل هذه الصورة:
“راودتني بعض الوساوس حينما تلكأ موزع البريد أياما، فقلت في داخلي: إن حسن شغلته الشواغل وما أكثرها لمن حوله وجنبه أسرة تنتظر منه الفصول الأربعة. ولكنك مع ذلك، كنت على مرمى حجر مني، فهنا في “الشمال” كنت ألتقي بك صورة وكلمات، فأستأنس بذاكرتك الخصبة، وبشاعريتك العذبة، وإن كنت في كل مرة بخيلا، لا تفيض في النجوى، فتفعل فعل شهرزاد التي تتوقف عند صياح الديك، ناسية أن الليل قادم لتحكي رغم أنفها، إذا شاءت الاستمرار في لعبة الحياة”.
ونجد شخصية عبد الكريم الطبال السامقة، المغموسة في ألق الشعر والجمال، تستحوذ صورها الرائعة على قلوبنا، صور منسوجة بذاته المتواضعة من مثل صورة:
“وبكل صدق، إني نسيت الجائزة والديوان معا، والذي أتذكره الآن هو ما سأكتبه وما سأقرؤه. دائما أعد نفسي من الفقراء الذين لا يملكون قصيدة واحدة، حتى أنالها إلى حين، لأعود فقيرا من جديد”
وصور عاشقة نسجها بيريش، تتوحد نبضات دلالاتها وألوان سحرها مع ما يسكن في قلوب عدد كبير من المحبين للطبال، من مثل صورة:
“لا يمكنك تصور الغبطة التي احتلتني، وشعور التأثر الذي تلبسني، وأنا ألتهم سطور رسالتك المتفجرة نبلا وحفاوة قل مثيلهما في زمننا الفظ هذا. بدوت أيها العزيز، كالعهد بك، شامخا كالطود، ودودا، متواضعا، أنيق العبارة، تنفذ شخصيتك المجبولة على بهاء الانسانية إلى صميم الدواخل. تلك شيمة المبدعين الكبار. وأنت مبدع كبير”.
صور أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها جميلة ورائعة، استطاعت بأسلوب بلاغي، بعيد عن التكلف وافتعال الصنعة، أن تضع القارئ أمام إشراقات تؤرخ لعلاقة إنسانية رفيعة، تحاور الواقع الثقافي، وتستنطق أزمنته، في محاولة بارعة للنفاذ إلى جواهر الأشياء والأحداث، وعرضها ببساطة وعمق.
وبعد،، لست بصدد تقديم “رسائل الغواية”، فهي تقدم نفسها للمتلقي عبر ألق الصورة ووهج العبارة وصدق التناول، إنما هي كلمات تعبر عن احتفالي العميق بها..
فشكرا أستاذي الرائع عبد الكريم ، والأخ العزيز حسن على هذه الباقات التي احتفظتما بها، وأشركتما معكما القارئ في التسلل إلى حدائقها العطرة، لاستنشاقها، ولاسترجاع بوح غزير يسكن الذاكرة، عسانا نتلقاه كما تلقاه الشاعر المهجري:
قَبَّلتُ في هَوَسٍ حُروفَ كِتابِهِ إنَّ الحُروفَ لها شِفاهٌ تُشتَهى